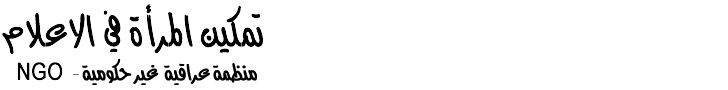مينا القيسي
سبع سنوات مرت على ذلك اليوم حينما استفاقت رؤى ليلاً من غفوّتها على ألمِ حاد يضرب صدرها تسبّب لها باختناق شديد وصعوبة بالغة في التنفسِ، الأمر الذي دفعها للاسراع لغرفة الطوارئ في مستشفى اليرموك في بغداد، إلا إنها صارت ترتاد ذلك المكان بشكلٍ متكرر لاحقاً.
كانت رؤى القيسي في الثالثةِ والعشرين من عمرها عندما شخص الأطباء اصابتها بمرض الربو وهي اليوم تدخل عقدها الثلاثين وتعمل مدربة لياقة بدنية. تقول إن مرضها كان مفاجئاً دون أي سابق إنذار، وانه أخذ بالتطور بشكلٍ مريب دون السيطرة على أعراضه التي أنهكتها، إذ إن نسبة الأوكسجين التي تدخل دمها أقل من متوسط النسبة الطبيعية بثلاثين ملليمتر.
تتابع رؤى: “أجريت العديد من الفحوصات الطبية التي كشفت لي وجود التهاب في الجهاز التنفسي وهشاشة واضحة تجاه قدرتي على تحمل ذرات الغبار التي تدخل مصاحبة للهواء الى مجرى التنفس، عند حدوث العواصف الترابية أو الرملية”.
وتضيف واصفة حالتها مع هذا المرض المزمن: “باتت ذراعي ممتلئة بوخزات الإبر، لا يوجد مكان لثقوب جديدة، وكثيراً ما افكر في ترك العلاج، اذ بات حدوث العواصف يخيفني وكثيراً ما أشعر بصداعٍ في الرأسِ لا يحتمل مع نحول عام في الجسم و سعال حاد يعيقني عن ممارسة حياتي بصورة طبيعية”.
في صيف السنة الماضية تعرضت بغداد لعشرات العواصف الترابية لوّنت سماءها بصبغة برتقالية كثيفة حدّت من مدى الرؤية وعطلت سير الرحلات الجوية، وأغلقت الدوائر والمدارس والمؤسسات العامة أبوابها، و دخل بموجبها أكثر من خمسةِ آلاف شخص إلى مختلف المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج، في غضون أقل من ثلاثة اشهر.
تعددت الأسباب التي ساهمت بتشكيل التدهور البيئي في العراق ككل، وبغداد بالأخص، وهي نفسها التي وضعت العراق في مصافٍ الدول الأكثر تأثراً بأزمة التغير المناخي العالمية. فعلى الرغم من كمية الأمطار التي هطلت في موسم الشتاء الحالي، إلا أن جفاف الصيف الماضي وارتفاع الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية، شكلا خطراً وتهديداً شديد اللهجة تجاه مستقبل البلاد البيئي بعد سنوات قليلة.
يتفق خبراء في مجال البيئة، على أن غياب الغطاء النباتي أو ما يسمى بالحزام الأخضر، في أي مدينة، هو أحد أهم الأسباب الرئيسية لحصول العواصف الترابية التي تتوالى أسبوعياً إن لم تكن يومياً، وبحسبهم، فإن بغداد تعاني من انحسار شبه تام لغطائها النباتي، الذي لم يشهد طوال سنوات أية خطوات جادة لإعادة انشائه أو تأهيل ما تبقى منه منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وإن كانت هناك مبادرات فهي لا تزيد عن كونها محاولات فقيرة لم تأتي بنتيجة حقيقية.
أمير علي الحسون، المتحدث بإسم وزارة البيئة العراقية يعزو أساس المشكلة الى التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية نتيجة الفوضى التي تسود البنى التحتية للعاصمة، فيقول: “هنالك ارتباط وثيق بين البنى التحتية لأي بلد وبين بيئته، و عندما يغيب الانسجام فيما بينهما ستكون النتيجة هي التدهور الذي نعيشه اليوم، والدولة هي المسؤولة عن صنع هذا التوافق”.
ويضيف “يسكن في بغداد أكثر من 9 ملايين نسمة، في ظل بنى تحتية قديمة لم تشهد تطوراً نسبياً يجعلها تتحمل هذا العدد الكبير، حتى أنها لم تضع احتمالية تعاظم ظاهرة البناء الفوقي الذي تجاوز الحدود المرسومة ضمن الخطة الرئيسية للسكن، واستشرى حتى وصل الأراضي الزراعية غير السكنية التي يفترض أنها مخصصة لمشاريع الأحزمة الخضراء”.
يشير الحسون أيضا إلى أن “وزارتي البيئة والزراعة العراقيتين، لطالما شكلتا لجاناً تتكون من حكومات محلية لوضع خطط استثمارية زراعية، لكنها دائماً ما تحول دون تنفيذها بسبب اصطدام هذه الخطط بواقع استملاك الأراضي الزراعية من قبل جهات متنفذة وقطاعات خاصة ترفض التفاهم”.
يعلل الخبير والناشط البيئي أحمد صالح نعمة فقدان الكبير للأحزمة الخضراء في العاصمة بغداد، فيقول: “تسببت الحرب على العراق ابان الحقبة التسعينية بقلة حصول الأفراد على حصتهم من الوقود، وأصبحت المنازل في مواسم الشتاء خالية من الغاز والنفط، فاضطروا بذلك للالتجاء الى قطع الأشجار بشكل كبير والاعتداء الجائر عليها ثم تحويلها الى حطب من أجل الطبخ والتدفئة”.
ويضيف: “لم تعمد الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2003 الى ايلاء الحزام الاخضر أهمية قصوى، وبالتالي فإن ما حدث كان نتيجة الإهمال المتراكم”.
وبرأي نعمة، فإن “حملات التشجير التطوعية التي حصلت طوال السنين من قبل المنظمات والنشطاء البيئيين هي حملات غير مدروسة، وقد تتعرض للفشل اذا لم يستعينوا بأفراد لديهم التخصص الدقيق الذي من شأنه الاختيار الصحيح لنوعيات الاشجار والمزروعات القادرة على تحمل ظروف البيئة القاسية التي تمتاز بها المدينة، والاطلاع بشكل علمي على طرق الزراعة والادامة والعناية”.
ويقول الباحث في الشأن البيئي خالد سليمان، إن “عملية زراعة الاحزمة الخضراء في المدارات المحيطة ببغداد ليست حلاً كافياً لمنع العواصف الغبارية من الولوج الى عمق المدينة، لأن حالة السيطرة على مصادر التلوث الداخلية لا تعني السيطرة على المصادر الخارجية؛ المتمثلة بالرياح الآتية من غرب العراق (محافظة الرمادي) وكذلك المناطق الحدودية للدول المجاوّرة”.
ويوّضح، “أصبحت هذه المناطق في السنوات الأخيرة مصدراً أساسياً للعواصف الرملية بسبب فقدانها للغطاء النباتي وتناقص كمية سقوط الأمطار فيها لسنوات متتالية، إضافة الى وجود عمليات عسكرية من قبل قوات التحالف والقوات العراقية ونشاط دائم للحركات العسكرية التي أدت لتعرية التربة”.
من جانبه، يوضح الأكاديمي المتخصص بالتلوث البيئي، إياد عبد المحسن أحمد أن “الأراضي المفتوحة والجرداء داخل العراق تمتد من مثلث الحدود التركية السورية، مع شريط في غرب العراق، داخلة في الأراضي السورية والأردنية، وصولاً إلى البصرة”.
ويؤيد أحمد بكلامه خالد ليقول: “أن المناطق الغربية المجاورة للعراق غير مستقرة الرياح، وتبعاً لذلك فإن العراق لا يحتاج أحزمة خضراء داخل المحافظات، بل يحتاج لتشجير في كل مناطق غرب وجنوب غرب العراق، حيث المناطق المتاخمة للدول العربية المجاورة”.
ويردف خبير الاستراتيجيات البيئية رمضان حمزة أن: “الرياح التي تجلب العواصف الترابية تقسم إلى قسمين، عواصف داخلية وعواصف خارجية، العواصف الخارجية تأتي من الصحراء الموريتانية ومن صحاري السعودية والكويت، كما تأتي من الصحراء الداخلية المنتشرة في الغرب والغرب الجنوبي من العراق”.
عفاف محمد (ام محمود) 65 عاماً، سيدة من بغداد تعاني من تحسس الجهاز التنفسي الذي يشمل الأنف والأذن والحنجرة، والذي يدرج ضمن الحساسية الموسمية، تقول: “بدأت لدي الحساسية عند عمر الأربع سنوات، انتبهت لي والدتي عندما كان يحل فصل الصيف وتتصاعد الرياح في الجو، فتصيبني نوبة شديدة متمثلة بالعطاس واحمرار العينين وسيولة في الأنف وتضخم اللوزتين وصعوبة في استنشاق الهواء، وكنت أنقطع عن الذهاب الى المدرسة لأيام عدة، وأقضيها في النوم لشدة تعبي”.
تضيف عفاف، ” لازمتني هذه الحساسية وصولاً إلى مرحلة الشباب، إلا انني لم اشعر في حينها إلى الحاجة الضرورية لمراجعة طبيب مختص، كون ظاهرة العواصف الترابية التي تضرب المدن لم تكن شائعة كثيراً في فترة الستينيات والسبعينيات التي عاصرتها، فهي كانت غير مألوفة، وحالات التأثر بها قليلة”.
وتبين أن الحال اليوم يختلف، “أصبحنا نشهد تكرار تلك العواصف الغبارية لأكثر من مرة في غضون أسبوع واحد، الأمر الذي استدعى مراجعتي لمركز الحساسية في منطقة العطيفية قرب طوارئ الكرخ، من أجل تشخيص حالتي وتوفير العلاج لها، بعد ذلك اضطررت لأخذ جرعات متتالية من اللقاح لمدة ستة أشهر للتقليل من أعراض المرض”.
وتضيف أم محمود بلهجة بالغة الحزن، “لا أنسى ابداً المواقف الحرجة التي حصلت لي بسبب الحساسية، خاصة ذلك اليوم الذي كنت فيه احضر حفلة زواج احدى صديقاتي في منطقة زراعية مفتوحة، ما ان هبت رياح حاملة معها ذرات قليلة من الغبار حتى تدهورت صحتي، فأجبرت على قطع الزيارة والعودة إلى المنزل”.
وتختتم حديثها بقولها: “كانت وما زالت أشهر مايس ونيسان وايلول منغصات بالنسبة لي، رغم انني تقاعدت عن العمل، الا انني ما زلت اتحفظ عن الخروج من المنزل خلال تلك المدة، واذا حصلت عاصفة ترابية صفراء فسريعاً ما ادخل في حالة إنذار، أغطي منافذ تهوية الأبواب والشبابيك بقطع قماش لمنع دخولها الى البيت، وأبلل شاش من القطن بالماء الدافئ ثم أضعه داخل كمامة طبية وارتديها، لأبدأ بعد ذلك بعملية تنظيف الأثاث من ذرات الغبار”.
“نحن الان وسط الكارثة”، هكذا ابتدأت التدريسية في كلية الزراعة بجامعة بغداد الدكتورة آفاق ابراهيم جمعة حديثها عندما فتحنا معها ملف التصحر وتأثيره السلبي على البيئة.
توضح الباحثة العراقية أن “النطاقات الصحراوية في العراق عددها سبعة، وهي تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي والغربي، وهي ليست صحراء انما تصحّرت، أي ان كل منطقة متصحرة يمكن معالجتها وإرجاعها كما كانت عليه في الأول، لكن على الجهات المسؤولة أن تتكاتف وتتعاون فيما بينها لان النتيجة التي نتطلع اليها تتطلب جهد دولة”.
صفاء الظفيري (25) عاماً من بغداد، يعمل في احدى الاذاعات العراقية، يقول: “أعاني من تحسس بالقصبات الهوائية اضافة الى التهاب الجيوب الأنفية، ولهذه الحالة أعراض شبيهة بأعراض مرض الربو إلى حد ما، قد بدأت معي منذ سن المراهقة إلى حد هذا اليوم”.
ويقول صفاء بأنه لو اضطر الى الخروج من المنزل أثناء الغبار، فهو يعمد إلى لبس كمامتين صحيتين أو أكثر، حرصاً على عدم نفاذ جزيئات التراب الى قصبته الهوائية.
ويوضح الظفيري ان لديه طبيباً مختصاً يراجعه منذ سنوات طويلة، للحصول على العلاجات الضرورية عند وقوع حالات الاختناق التي تراوده، ويؤكد ان في ذلك مردودات نفسية سلبية عليه، وتكاليف مادية كبيرة نتيجة غلاء الأدوية الخاصة بمرضى الحساسية والربو.
حلول مقترحة
يذهب أمير علي الحسون الناطق باسم وزارة البيئة الى أهمية اعتماد التوسع العمراني العامودي للمدن، الذي من شأنه احتواء الزخم السكاني الحاصل وابطاء الزحف العمراني، لأن هذا النوع من التوسع يتطلب مساحات أقل بكثير من الأراضي مقارنة بالتمدد الأفقي، حتى لا يضطر السكان إلى مخالفة القانون والزحف على المساحات الخضراء وقطع الأشجار والمزروعات ليبنوا مسكناً عليها.
ويؤكد حسون، ان سنة 2023 هي سنة العمل الجاد للتصدي للتغيرات المناخية، لأن وزارة البيئة العراقية تتولى تنفيذ خطة التكيف البيئية الخاصة بالتغيرات المناخية، والتي تشمل إنشاء احزمة خضراء جديدة حول العاصمة بغداد، وهي خطة تم إطلاقها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وجميع وزارات الحكومة ملزمة بتنفيذها كلّ حسب دوره، وبدعم من الأمم المتحدة التي تعتبر الطرف المساعد للاتفاقات الدولية بخصوص تدعيم القدرات المحلية والمؤسسات البيئية.
أما رمضان حمزة ، فيوضح مواصفات الحزام الأخضر لمدينة بغداد قائلاً: “يجب ان يكون بطول عشرات الكيلومترات، وعرض حوالي 100-200 متر، لكن في البداية يجب إجراء دراسة جدوى لتحديد اتجاهات الرياح وتحديد مستويات التصحر وأسبابه”.
أما الدكتور إياد عبد المحسن أحمد فيبين أن “الزمن المثالي لزراعة الأحزمة الخضراء هو الشهر العاشر من كل عام، إذ يتزامن ذلك مع هطول الأمطار خلال الأشهر اللاحقة، وبالتالي سوف تسهم البيئة في تقليل كلفة السقي، مع زراعة نباتات مقاومة للظروف القاسية، مثل شجرة النيم، كونها مقاومة لقساوة الطقس والتربة، فضلاً عن شجرة الأثل، التي تتميز بجذورها القوية والجاهزة للزراعة في أي مكان، وعندما ينبت الأثل فإنه لن يموت، وأشجاره تتميز بارتفاعها الشاهق، متميزاً بكونه مصد رياح وغبار، كما تسهم بالحفاظ على سطح التربة من التعرية”.
ويؤكد على ضرورة الالتفات لإنجاز مشروع حزام وطني بحدود ألف كيلومتر طولاً وبعرض ثلاثة كيلومتر على أساس احتساب 20 مترا مربعا للشجرة الواحدة.
ومع افتراض أن نسبة النجاح في زراعة الاشجار تبلغ 70% أي موت المزروعات بنسبة 30%، فإن المشروع بحاجة إلى أكثر من 220 مليون شجرة من مختلف الأنواع.
ويشدد أحمد، على أن “سقي الأحزمة الخضراء داخل العراق لا يحتاج الكثير من الأموال، إذ يمكن للعراق الاستعانة بحفر الآبار الارتوازية، لاسيما وأنه يحتل المرتبة الأولى في الوطن العربي من حيث الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية، وبالتالي يمكن الاستعانة بتقنية السقي بالتنقيط، وعدم هدر المياه بطرق سقي تقليدية، فضلاً عن الاستعانة بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والرياح، لتشغيل المضخات وسحب المياه من الأرض”.
أما د. افاق أبراهيم جمعة فتجد ان لا حاجة لانتظار حل أزمة المياه قبل الشروع بعمليات انشاء الحزام، لان الحل يكمن في الإختيار الأمثل للنوع النباتي بشكل علمي يتيح له العيش لمدة طويلة واستثمار المياه بشكل أكثر كفاءة.
وتوّضح، أن شجرة الأكاسيا العربية هي شجرة متحملة للجفاف ولا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه، إضافة الى نبات الأثل وهي شجرة دائمة الخضرة يمكن ان يصل ارتفاعها الى 18 متراً وتعمل كمصد للرياح.
والحال نفسه مع شجر “اوكالبتوس كمالدولي” فهو كبير الحجم وسريع النمو، يزرع على جانبي الطرق لتوفير الظل من خلال اوراقه المتهدلة، إضافة إلى شجر “البومباكس” الذي ينمو بشكل جيد في المناطق الجافة ولديه القدرة على تحمل الظروف البيئية القاسية، ويوجد الكثير مثلهم كالنخل، والزيتون، والسدر، والتوت، والبمبر وهي نبتة دوائية، بحسب د. جمعة.
تخرج رؤى الشمري من منزلها صباح كل يوم متجهة الى الساحة الرياضية وتبدأ في تدريب طلابها، تهرول معهم مسرعة في ميدان الركض ثم تتوقف لاهثة لشرب الماء من العبوة الزجاجية التي تحملها معها أينما ذهبت.
وتقول: “لقد تركت الدواء الخاص بحالات اختناقي الشديدة في درج الخزانة منذ فترة طويلة، واتمنى ان يبقى هنالك للأبد، لانني تعبت من مصاحبته معي اينما حللت”.